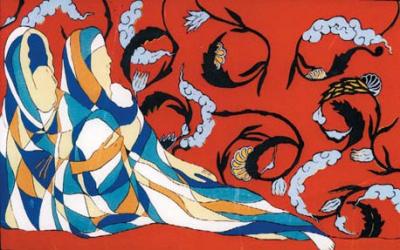تقنيات الحوار في شعر أحمد العواضي
أحمد صالح الفراصي

أحمد صالح الفراصي –
إن المتأمل في الدراسات النقدية التي تتطرق إلى الحوار سيجد أنه قد تعددت تسمياته وأقسامه إذ يعرف الحوار بأنه : ” حديث يجري بين شخصين أو أكثر في العمل القصصي أو بين الممثلين على خشبة المسرح ” (1) بل أن هناك من يوسع أفق الحوار إلى خارج حدود العمل الفني فهو ـ أي الحوار ـ وإن بدا في الظاهر حوارا بين شخصين أو أكثر فإنه ” في حقيقة الأمر غير محصور في هذا المدى المنظور وإنما يمر عابرا إلى المتلقي الذي يكون بمثابة الشخص الثالث غير المرئي بين هذين الشخصين المتحاورين في موقع داخل النص ” (2) .
وإن كانت هذه التعريفات تشير إلى نمط واحد من الحوار وهو الحوار الخارجي فإن بعض الدارسين قد عرف الحوار بكونه : ” حديثا معلنا أو مضمرا بين طرفين أو أكثر يقيمه الشاعر في القصيدة أو يوحي به ليعبر من خلاله عن شعوره الداخلي أو يعرض فيه لفكرته ويحاكي واقعه ويبين معاناته بطريقة فنية وإبداعية مؤثرة ” (3) وهو التعريف الذي لا يخفى ما فيه من تمييز بين أنماط الحوار فهناك حوار معلن ” يجري بين طرفين يسوق كل منهما من الحديث ما يراه ويقنع به ويراجع الطرف الآخر في منطقه وفكره قاصدا بيان الحقائق وتقريرها من وجهة نظره ” (4) بحيث يتم الحوار بينهما بطريق مباشرة لا تسمح بتدخل شخصيات أخرى في إيصال حوارها أو أن تجري عليه أية تعديلات (5) ولعل من أهم ميزات هذا الشكل الحواري هو كثرة ” الجمل التعجبية والاستفهامية والأمر والطلب وما إليه” (6) .
وقد ينقل الحوار بطريقة غير مباشرة يتم فيها نقل حوار أحد الطرفين إلى طرف ثالث غيرهما باستخدام صيغة الزمن الماضي الذي يستثمر فعاليات ضمير الغائب المتكئ على صيغ أفعال القول المبنية على أساس المحاورة / مثل : قال قلت قالت سأل سألت …(7) وسواها من أفعال القول ومشتقاته التي تعيد نقل الحوار إلى متلق جديد بصيغة ملخصة ـ غالبا ـ دون تقيد من السارد بالنقل الحرفي لمجريات الحوار الأصلي المباشر” محافظا على هيكل الفكرة والتصوير متصرفا بهيكل البناء القولي من حيث زمنه وإشاراته التخاطبية ” (8) وهذا الحوار الخارجي بنمطيه المباشر وغير المباشر هو ما عرف في الدرس النقدي الحديث بـ (الدايلوج)Dialogue (9) .
كما أن هناك نمطا آخر من الحوارـ وهو ما يعنينا في هذه الورقة ـ وهو الحوار الذي يختص بالذات وحدها حين ” يحاول فيه المحاور أن يصنع لنفسه طرفا من داخله ويتحاور معه ولكنه مع ذلك يبقى حوارا روحيا داخليا أو سرا شخصيا لا يمكن الاطلاع عليه إلا إذا أفصح عنه المحاور ” (10) وهذا الحوار الذي يستل من الذات شخصا آخر تتوجه بالحوار إليه يكون فيه الصوتان لنفس الشخص المتحدث ” أحدهما صوته الخارجي العام أي صوته الذي يتوجه به إلى الآخرين وآخر صوته الداخلي الخاص الذي لا يسمعه أحد غيره ” (11) وذلك الصوت الخارجي العام عرف عند معظم الدارسين بـ (المونولوج)Monolgue (6) ذلك لأنه يعد بمثابة “البوتقة التي يحدث في داخلها ذلك التفاعل بين الحياة والحقائق السائدة حيث يتم النظر إلى الحياة ومحاولة تحديد أبعادها أو حتى تشويهها عن طريق وجهة نظر شخص معين في زمان ومكان معينين” (12) لتنعكس من خلاله هموم الذات وأحلامها وأمانيها وتصوراتها عن الناس والحياة عبر” حديث داخلي يتصل بالعالم الجواني للإنسان الذي يجد لنفسه فرصة تأمل وإعادة تركيب لمشهد الحياة على وفق رغباته” (13) فيقذف من خلاله بما يختلج في داخله من أفكار ومشاعر يعرضها بحرية كاملة كاشفا عن البواعث والخواطر والمحفزات التي تكمن ورائها .
وأما الصوت الداخلي الخاص فهو الصوت الذي ينطلق من الذات ويعود إليها مباشرة إذ لا يعني المحاور شيء غير ذاته وما يعتمل فيها من هواجس وقناعات فينظر إليها ” من منظور عام … فلا يكتفي بالتعبير عن أبعاد شخصيته وأحاسيسها الداخلية ودوافعها لكنه يتعدى ذلك إلى محاولة فهم نفسه بتعقل” (14) وبحسب هذا التحليل فأن هذا النمط من الحوار يبدو أعمق غورا في الذات من المونولوج بل لا نبالغ إذا قلنا بأنه هو قطب الحوار الذاتي وعموده الأساس لاسيما وأن المحاور لا يعنى بأي شيء خارج الذات كما في المونولوج بل يعنى بالذات وقناعاتها ومقدار فهمها للحقائق أولا وأخيرا فهو يتساءل عن قناعاته تلك ولا حاجه له بالجواب عنها من شيء يتصل بالخارج بل يترك الإجابة تأتي من نفسها ومن داخل الذات لا من خارجها بحيث يلجأ إليه الشاعر” حين تتصاعد أزمته فلا يجد متنفسا خارج حدود الذات لذلك فأنه وبوعي إبداعي يغلق أبواب ذاته ونوافذها لتغدو جدارا صفيقا أملس إزاء وعورة العالم خارج الذات . وغالبا ما يأتي البوح مضمخا بعبير التأمل وشذا الحكمة ومعاتبة الذات بغية المصالحة معها والانغمار في أجو