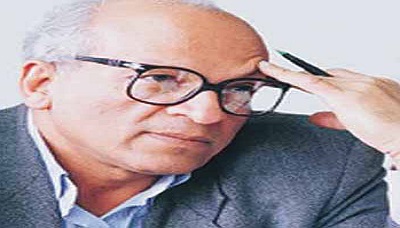د. عبدالعزيز المقالح
تلقى ملايين القراء في الوطن العربي بأسىً شديد رحيل الكاتب والروائي الكبير جمال الغيطاني بوصفه واحداً من نجوم الإبداع العربي الحديث والمعاصر. وكان صديقاً حميماً لكل المبدعين العرب على اختلاف توجهاتهم وإنتماءاتهم. وكان لي شرف معرفته عن طريق كتاباته أولاً، ثم من خلال لقاءاتنا التي بدأت في منتصف سبعينيات القرن الماضي ولم ينقطع التواصل بيننا حتى لحظة رحيله في هذه الأيام القاسية التي صار التواصل فيها صعباً والظروف لا تطاق.
عرفت جمال في البداية من خلال مجموعته القصصية الأولى “أوراق شاب عاش منذ ألف عام” التي جعلته يشق طريقه نحو عالم الأدب بسرعة البرق وأثبتت ميلاد كاتب موهوب في دنيا السرد الذي بات يشكل العمود الفقري في الأدب العربي والعالمي. أما معرفتي الشخصية به فقد تمت لأول مرة في أحد اللقاءات الاسبوعية التي كان يعقدها الروائي الكبير نجيب محفوظ في مقهى ريش بالقرب من ميدان سليمان جوهر في قلب القاهرة، كان جمال ودوداً ووديعاً متواضعاً، يختلف في حديثه وتعليقاته وإشاراته عن بقية الحضور. وقد تعمقت صداقتنا عبر الأيام، وذات يوم أجرى معي مقابلة للنشر في الصفحة الثقافية لجريدة الأخبار القاهرية التي كان يشرف عليها وقد تركز أحد الأسئلة عن الرواية العربية، وقد أجبت عليه أن الفن الروائي ولد في الغرب وفي أوروبا على وجه الخصوص، لكنه أوقف الحوار معترضاً ودخل معي في نقاش طويل مؤكداً فيه أن القص العربي هو الأصل وأنه هو الذي ترك أثره في كثير من لغات العالم. وفي المقدمة اللغات الأوروبية والإنجليزية والفرنسية والألمانية.
وكان لديه كل الحق فيما ذهب إليه فقد دخلت أوروبا إلى عالم السرد عن طريق ألف ليلة وليلة ابتداءً من “دون كيشوت” وحتى آخر أعمال بورخيس وجاء أكبر تأبيد لافتراضاته تلك ممثلاً في إبداعات أمريكا اللاتينية التي استمدت واقعيتها السحرية من الحكايات العربية التي تسربت إلى هناك عبر الترجمات وذلك بعض ما حملته اعترافات أساطين الرواية في ذلك الجزء من العالم وفي الطليعة غابريل ماركيز وباولوكويلو ولم يقف جمال الغيطاني عند هذا الحد من التأكيد على أولوية الرواية العربية أو بالأصح “القص العربي” بل أنطلق إلى مدار التجريب في تغيير لغة الرواية العربية مستفيداً من الأسلوب القصصي والحكائي الموروث وكانت روايته الأشهر “الزين بركات” نموذج هذا التجريب الفريد الذي يربط الحاضر بالماضي ويؤكد للعالم أن العرب مبدعون لا ناقلين وصانعو ثقافة لا متسولي ثقافة.
لقد بقيت على تواصل دائم مع جمال وجمعتنا لقاءات حميمية في صنعاء ورافقته في تنقلاته واكتشافاته لصنعاء القديمة وشاركته افتتانه وإندهاشه بالموروث المعماري لهذه المدينة ولمدن صغيرة أخرى أراد أن يقيم فيها طويلا لولا مشاغله الوظيفية لاسيما بعد أن نجح في إنشاء وتولي مسئولية ” أخبار الأدب” التي شكلت بإشرافه ومتابعته “بانوراما” عربية تجمع أدباء العربية من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب ، ذلك هو جمال الغيطاني الروائي الكبير الذي أفتقدناه بل خسرناه في مرحلة الخسارات العظمى التي تلحق بالعرب في كل مكان ولا يكاد ينجو منها قطر عربي مهما حاول أن يكون في منأى عما يحدث أو يهرب بجلده العربي بعيداً عن الكوارث والعواصف أو حاول التخلي عن مواجهته للمخططات المعدّة للوطن العربي منذ عقود ليدخل مع نفسه في حروب تؤدي إلى آخر حلقة من حلقات التفكيك والتفتيت.
ولا يمكن الحديث عن جمال الغيطاني الروائي في منأى عن الإشارة إلى دفاتره التي جمع فيها أحاديث رحلاته وملامح من سيرته الذاتية في كتابات اتسمت بالخصوصية والعذوبة والرقة وجمال التعبير والتصوير.
ومن إقترابي الحميم بالراحل الكبير أدركت اهتمامه الواسع بثلاثة أقانيم: القاهرة القديمة ، ونجيب محفوظ ، والأمة العربية . كما أكتشفت مدى اعجابه بالصوفية والمتصوفة، وأنه وجد في الرؤى الصوفية مصادر إلهام لا تنتهي للفنون والآداب وللتأمل وتحرير النفس من قلق العصر وأفاته ، وهذه الإشارة تجعلني أؤكد أنه رغم إنشداده إلى هذا التيار التأملي فقد كان عقلانيا مرتبطاً بالواقع وبقضايا الناس ، كما كان مشدوداً إلى البسطاء منهم ولن أنسى آخر ما رأيته له من برامجه المتلفزة ذات نهار جمعة في أحد المساجد الصغيرة النائية شبة المندثرة ، والمسجد يحمل اسم أحد الأولياء ، كان جمال يتحدث مع الحارس العجوز وهما يشربان الشاي والحوار يدور حول ذلك المسجد وعدد الناس الذين يزورونه أو يؤدون الصلاة فيه.
لقد ارتسم ذلك المشهد في ذاكرتي ولم يبرحها وهو ما أراه حين أتذكر جمال أو أقرأ له أو عن تاريخه الحافل بالإبداع والبحث الدؤوب عن المعالم التي تحمي وجدان الإنسان العربي وتربطه بتاريخه الثقافي والروحي ، سلام الله عليه في خلوته الجديدة ، هناك في مقابر الخالدين والمنسيين من أبناء مصر العظيمة الطاهرة.